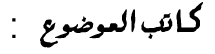لتجربة قراءة أفضل تفضل بزيارة المقالة على زد

"
الإنسان عدو ما يجهل" هكذا تقول العبارة الشهيرة.. ولكن هل هذا فعلًا حقيقي؟ أم أن جهلنا يجعلنا نكره أشياء مفيدة ونحب أشياء ضارة؟ وبذلك يصبح العدو الحقيقي صديقًا، والصديق الأمين عدوًا.
حسنًا، لنتناول ذلك من خلال رحلتي مع عقارات تسكين الألم.في عائلتي يتعامل الناس مع المُسكّنات كما لو كانت قطعًا من الحلوى، وظللت أفعل مثلهم لوقت طويل. بمجرد أن أشعر بالألم أتوجه نحو حبات المسكّن، والتي بطبعها رائعة في إخفاء الألم تمامًا، الغريب أن جسدك يتعود مع الوقت على ما تتناوله، ومع الوقت تصبح الجرعة التي اعتدت عليها غير كافة لتسكين ألمك، فتتناول جرعة أكبر أو تلجأ لمسكن أقوى، وهذا ما حدث لي بالفعل! حتى وصلت إلى عامي الثالث من دراستي للطب، ودرست طريقة عمل المسكنات في جسدنا، وكيف نتخلص من تلك المواد بعد أن تنهي عملها بداخلنا.
ومن هنا صرت أعرف المسكنات جيدًا، وأصبحت عدوة لما أعلم بعدما كنت صديقة لما أجهل.معرفتي لطبيعة عمل المسكنات، وتأثيرها السلبي على أجهزتنا الحيوية كالكُلى مثلًا، جعلني أفكر:
إلى متى سيتحمل جسدي تلك المواد؟ ومتى تتوقف الكُلى عن محاولاتها لتنقية دمي وإخراج ما يضرني؟ ولو أني استمريت على تناولي لحبات المسكن بهذا المعدل؛ فما الذي سيكون عليه حال جسدي بعمر الستين مثلًا؟عقدت العزم على تجنّب المسكنات بالتدريج… وصرت لا أتناولها إلا عند الضرورة القصوى، ومع الوقت تضاءلت ضروراتي القصوى التي تجبرني على أن أكون بخير ظاهريًّا بينما جسدي ليس كذلك، وأصبحت صحتي هي ضرورتي القصوى، والجميل أنني بمرور الوقت وتعوُّدي على قلّة المُسكّنات أصبَحت أقلّ جُرعة منها تَكفِيني لإِسْكات أَلَم لا أتحمله، فنِصف قُرْص من المسكن يجعل الألم الشديد يتلاشى تمامًا.وهكذا بفضل الله وكرمه صار الألم صديقًا لي بعد أن كان عدوي الأول لأني كنت أجهله. وبعد إدراكي أنه ما هو إلا رسالة لتنبيهي على خلل ما في جسدي، صرت أتوجه نحو علاج الخلل، وليس إيقاف الألم العارض، وصار المسكّن في قائمة الأعداء. أذكر أنني منذ قرابة ستة أشهر اضطررت لتناول المسكّن، كنت أشعر بألم شديد وبمجرد ما تناولته بدأ الألم يختفي بالتدريج حتى صرت أشعر أني بخير تمامًا.نسيت الألم وصرت أمارس نشاطاتي الطبيعية. وبعد عدة ساعات اختفى أثر المسكن وعاد الألم كما كان. وتركت كل ما كنت أفعله لآخذ قسطًا من الراحة، في تلك اللحظة بالذات كرهت المسكّنات كلها. لقد كان جسدي في حاجة للراحة، ولاحترام ما يمر به من ضعف، يتطلب أن أريحه. وما كان الألم سوى حديث من جسدي إليّ عبر اللغة الوحيدة التي يعرفها، وتساءلت حينها:
لِم عليّ أن أكون بخير بينما لست كذلك في الحقيقة؟ لِم عليّ أن أعمل وأنجز بينما يحتاج جسدي للراحة؟ هل أعامل جسدي كآلة لا احترام لها؟ ألا يحق لجسدي أن يطلب إجازة؟ ألا يجب عليّ أن أسمح لجسدي بالتعبير عن نفسه وأن أصغي له باهتمام؟ لِم نسعى نحو إسكات أجسادنا؟ ولم علينا أن نكون بخير دائمًا، مستعدين للعطاء وللعمل ولإنجاز كل شيء حتى على حساب صحة أجسادنا؟
أدركت حينها أن قراري كان صحيحًا تمامًا.إن توقفي عن المسكنات جعلني أتسائل حول كل ألم أشعر به، وأسرع في علاجه، بدلًا من محاولة إسكاته وتشويش عقلي عن التفكير فيه.وصبري على تحمل الألم جعل مني شخصية أقوى، ودفعني نحو التعرف على نفسي أكثر وأكثر. وألهمني التفكير بعمق في فلسفة الألم، وفي جدوى الحياة بشكل عام، ولا أقصد أبدًا أن أدفع أحدًا نحو تحمل الآلام الصعبة الناتجة عن الأمراض الخطيرة أو الجراحات الكبرى، ما أقصده هو الألم الذي نشعر به على مدار اليوم.. كألَم الصداع. أو الآلام التي تتكرر باستمرار كألم الدورة الشهرية لدى النساء.. وهكذا.أستطيع الآن أن أحدث تعديلًا بسيطًا على المقولة الشهيرة لتصبح "الإنسان عدو ما يجهل أو صديق له" المشكلة ليست في الشيء بذاته وإنما في جهل الإنسان.لذا علينا أن نعيد النظر في تصوراتنا عن الأمور من حولنا. وأن يسأل كل واحد منا نفسه: لم أتجنب ذلك الشيء، ولم أنجذب نحو هذا؟وعندما نكتشف جهلنا بحقيقة الأمور تكون تلك هي البداية لنتعلم، ونعيد صياغة تصوراتنا عن الحياة بالتدريج وعن وعي ومعرفة، لا عن جهل وتقليد أعمى للسائد حولنا.
إليك أيضًا
تابع قراءة عشرات المقالات الملهمة على زد