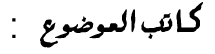لتجربة قراءة أفضل تفضل بزيارة المقالة على زد

إذا قمنا بعمليةٍ حسابيةٍ بسيطةٍ لنسبة غير الأمّيين إلى عدد سكان العالم العربي، فإننا نجد أن نسبتهم لا تزيد على عشرين بالمائة، وإذا أخذنا عدد المثقفين فقد لا تزيد نسبتهم على عشرة بالمائة. وهذه النسبة ضئيلة جدًا إذا قورنت بغيرها من النسب المتوفرة في الدول المتقدمة. مما يجعلنا نطلق حكمًا عامًا علينا، وهو أننا أمة لا تقرأ، على سبيل تغلّب غير القارئين على القارئين.
يتعين هنا تعريف المصطلحات التالية: الأمّي، اللا أمّي، المتعلم، القارئ (المثقف)، القراءة.
- الأمّي: وهو الذي لا يعرف فك الحروف وتركيبها، أي لا يعرف القراءة والكتابة.
- اللا أمّي: وهو الذي يعرف فك الحروف وتركيبها، أي يعرف القراءة والكتابة.
- المتعلم: وهو الذي يدرس في مؤسسةٍ تعليمية (مدرسة، معهد، جامعة … إلخ)، وحصل على شهادةٍ توضح مستوى التعليم الذي ناله ونوعيته.
- القارئ (المثقف): وهو الذي لم يكتفِ بمحو أمّيته، ولم يكتفِ بالحصول على الشهادة، بل تجاوز ذلك إلى القراءة الحرة والتثقيف الذاتي.
- القراءة: عملية تعرف بحتة، ثم تطور مفهوم القراءة إلى أن أصبح عبارة عن عملية تعرف ونقد وتطبيق للمادة المقروءة.
القراءة الحرّة: تنمية المواهب والهوايات والتخصصات التي تتمتع بها بمتابعة القراءة في المواضيع التي تشبع هذه الهوايات والتخصصات من دافع داخلي تفرضه علينا حاجات تدعونا دائمًا إلى إشباعها.
ولعلماء النفس رأي في القراءة يقول: القراءة أساس التعليم بمعناه المعروف، فالشخص الذي يقرأ شخص نام وقادر على الاستمرار في النمو . ذلك لأن القراءة نتيجة للنمو، وهي تؤدي إلى زيادته، وبذلك تكون القراءة مظهرًا مهمًا من مظاهر الشخصية، وهي فوق ذلك عامل هام من عوامل نموها.
وبناء على التعريفات السابقة فكل متعلم لا أمّي، وليس كل متعلم قارئًا، فكثير ممّن يحملون شهادات مدرسية أو جامعية يعودون إلى المرحلة التي كانوا عليها قبل حمل الشهادة نتيجة انقطاعهم عن متابعة القراءة، ولقد أثبتت البحوث أن متابعة القراءة ضرورية ولا سيما للمتخصصين، حتى تكون نتائج بحوثهم وقراءاتهم ليست تكرارًا لبحوثٍ وقراءاتٍ سبقوا إليها. ويحتاج الباحثون دائمًا إلى آخر البحوث والتجارب التي صدرت للاطلاع عليها.
وخاصةً في هذا العصر الذي يطلق عليه المتخصصون عصر انفجار المعلومات.
ولتوضيح ذلك يمكن أن يقال أنه يصدر الآن سنويًا في ميدان العلوم البحتة والتطبيقية حوالي 55000 مجلة علمية تنشر البحوث بصفةٍ دورية، وتشمل هذه الدوريات على ما يقرب من 1.200.000 مقالةً علمية وفنية وذلك فضلاً عن 60.000 كتاب و100.000 تقرير بحث على وجه التقريب، وقد تبيّن في بحث أُجري في الخارج أنه يصدر كل دقيقة دون انقطاع أكثر من 200 صفحة، من كتابٍ أو مجلةٍ أو تقرير بحث.
ومعنى ذلك أنه إذا استمر أحد الباحثين في القراءة بسرعةٍ متوسطةٍ وبلا انقطاعٍ ليحيط بكل ما نشر في فروع المعرفة لتخلف عن القراءة بحوالي 1.000.000.000 صفحة، كل عام، فكيف بالذي ينقطع عن المتابعة بتاتًا.
وبشكلٍ عام هناك ظاهرة تثير الاستفهام أو بتعبيرٍ أصدق، الغرابة. وهي أن ظهور وانتشار التعليم وحب القراءة في البلدان المتقدمة كأمريكا وروسيا … إلخ، كان مرتبطًا بظهور الدين والحركات الإصلاحية. ولنأخذ فرنسا مثالاً على ذلك: فالقراءة الجماهيرية تبدأ مع الثورة الفرنسية، وقد أدرك الشعب أنها طريقة للخلاص والتحرر. ولكن القراءة الشعبية الفعلية لم تبدأ في فرنسا إلا في الفترة ما بين 1830 وسنة 1848م، وعلى الأخص منذ إصدار القوانين التعليمية ( قوانين جيزو في عام 1833م) التي أقامت مدرسة في كل قرية. فقد كان سبعون في المائة من الفرنسيين أميين وفي بضع سنوات تحولت النسبة إلى ثلاثين في المائة. وكانت هذه هي الوثبة الحقيقية.
ومثل هذا حدث في الدول العربية، فهي ليست أقل حظًا من الحركات الإصلاحية فقد مرّت بحركات إصلاح شتى في سبيل التحرر من الاستعمار. ثم إن القرآن والسنة النبوية والديانات الأخرى (المسيحية) ليست بالدين الجديد علينا.
وبالرغم من هذا التشابه بيننا وبينهم وبالرغم من توفر ثقافة الكلمة المكتوبة فيما زلنا نعتمد على ثقافة الكلمة الشفهية. فلماذا لا نكون أمة صفتها وعادتها القراءة. ولماذا نسينا أننا كنا كذلك أيام البيروني، وابن سينا، والفارابي، والزهراوي، والرازي … الخ.
لماذا لا نقرأ وليس هناك من يدعونا إلى عدم القراءة . إن الإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل . إذ فما هي الأسباب ؟ لا يمكن أن نقول عنها أسباب، ولكن عدم انتشار القراءة لدى الأغلبية من الناس يرجع إلى شعورهم السلبي الذي تخلقه عوامل وأجهزة واقع تنظيمها وإدارتها تؤثر بطريقة عمدية وبطريقةٍ غير مباشرة على خلق هذا الشعور.