أصبحت الهواتف الذكية كارثة على الطلاب والمعلمين، فالطلاب لا يركزون في الدروس بقدر تركيزهم في محادثاتهم وألعابهم وتعابير الوجوه
لتجربة قراءة أفضل تفضل بزيارة المقالة على زد

لطالما عانيت بصفتي معلمة في استحداث سياسة فعالة لاستخدام الأجهزة الذكية في القاعات الدراسية. حيث شهدتُ لوقت طويل وبقلق، تأثير التقنية على الصف. وكنت آمر الطلاب بالغناء أو الرقص إذا قاطعت هواتفهم الدرس. وأصبحت هذه التجربة فيما بعد ذكرى لا تنسى، إلا أنها جعلت الأمر لا يؤخذ على محمل الجد. ونظراً للأضرار الكبيرة المترتبة على استخدام الجوالات مثل: الإدمان، وقلة التواصل الاجتماعي المباشر، وقلة المهارات والتشتت اللامنتهي، أرغب مبدئياً بحثّ الطلاب على التفكير بتغيير عادات استخدام هواتفهم بدلاً من الاتباع الأعمى للقوانين.
حقائب خاصة تمنع استخدام الهواتف أثناء الدروس
وتواصل معي ممثل شركة ناشئة في سان فرانسيسكو تُدعى (
يندر)، بعد قراءة مقالي بهذا الصدد في مجلة (أيون). وقد أصدرت هذه الشركة حقائب خاصة تمنع الجماهير من استخدام هواتفهم أثناء العروض، فبعد وضع هاتفك على الصامت، تدخله في حقيبة (يندر)، وتغلقها بإحكام من الأعلى، وبذلك لا يمكنك فتح القفل إلا في البهو بعد انتهاء العرض أو قبله إذا دعت الضرورة لذلك، عن طريق تمريره على قاعدة معدنية شبيهة بطريقة إزالة بطاقات حماية الملابس من السرقة. وقد استخدمه الممثلان (ديف تشيبل) و(أليشيا كيز)، وعُرفوا بشعارهم "كن هنا الآن" لمنع التسجيل بدون إذن مسبق، ولرؤية أوجه الناس بدلاً من هواتفهم. وتبدو الطريقة أقل تعسفية من إجبار الناس على التخلي عن أجهزتهم، مما يولد لديهم قلق الانفصال الذي يحبط هدف زيادة المشاركة المجتمعية. أرسلت إليّ شركة (يندر) حقائب لاستخدامها في القاعة الدراسية. وفي بداية الفصل الشتوي، عرّفت طلابي على الروتين المعتاد، فيجب عليهم قبل كل درس وضع الهاتف على الصامت، ثم أخْذ إحدى حقائب (يندر) من الصندوق، ووضع الهاتف بداخلها، وبعد الانتهاء يُفتح القفل، وتعاد الحقيبة إلى الصندوق. وبذلك لا أهتم إذا ما وضعوا الحقيبة على الطاولة أو في جيوبهم أو أمسكوها بإحكام أثناء الدرس. وأخبرتهم بأن هذه تجربة ستنتهي بكتابة مقال، لذلك أريدهم أن يكتبوا آراءهم بصدق في الاستبيان حيال ما يحدث والذي سأجمعه في بداية ونهاية الفصل الدراسي. مبدئياً، كان ٣٧% من أصل ثلاثين طالباً في جامعة (بوسطن) غاضبين أو منزعجين من هذه التجربة؛ لأن سياستي السابقة قائمة على الإذلال بشكل علني، فلم تُملي عليهم ما يفعلوه بأجهزتهم، إذ يرى البعض أن وضع هواتفهم في حقائب (يندر) أشبه بحبس حيوان أليف في قفص، فهو حرمان صريح من الحرية. وفي نهاية الفصل الدراسي أبدى ١٤% استياءهم من الحقائب. فيما كانت مفاجأة سارة لـ ١١%. وأبدى ٧% ارتياحهم. وشعر ٢١% بأنها فكرة جيدة.
الأثر الإيجابي من تقليل استخدام الهاتف داخل الصف
تظهر الحلول الوقتية سريعاً، فقد كان الطلاب يضعون جوالاتهم في حقائب (يندر) دون إقفالها. ولكونهم ما يزالون لا يستطيعون استخدامها، فتُعد هذه حركة تمرد، بدلاً من مظاهرة تحدٍّ. فقد استخدم بعض الطلاب أجهزتهم المعدّة للبحث في قواعد البيانات، وإكمال التدريبات في الصف، لتصفح شبكات التواصل الاجتماعي. ولكن إذا استخدموا أجهزة الحاسب الآلي فيما منعهم منه (يندر) فهذا اختيارهم، ولن أضع قيوداً على استخدامه. فحقائب (يندر) منعت الطلاب من الذهاب إلى دورات المياه لاستخدام هواتفهم. ففي الفصول الدراسية الماضية كان بعض الطلاب يغادر القاعة الدراسية، برفقة هواتفهم إلى دورة المياه، لمدة تتراوح بين عشر إلى خمس عشرة دقيقة، أما الآن فقد قلّت نسبة الذهاب إلى دورة المياه. توقع ٢٦% من طلابي - ما يقارب الربع - أن (يندر) سيخلق بيئة مثالية للتعلم. وأكد هذا ٥١.٨٥% منهم – أي ضعف العدد - في نهاية الفصل الدراسي. لكن لا يمكنني الجزم ما إذا كان هذا اعتراف على مضض أو اعتراف جاد، تماماً كعلمهم أن البروكلي لم يكن سيئاً جداً كما كان يبدو. وقد لاحظتُ ذات مرة أن إحدى الطالبات نسيت حقيبة (يندر) تحت الطاولة، وعادت بعد برهة قائلة: "لقد نسيت تماماً الهاتف بعد أن وضعته في الحقيبة". فربما عنى هذا أنهم كانوا يعملون؟ أو كانت تحلم بشيءٍ ما؟ أو كانت تقوم ببعض الخربشات الجميلة؟ وهناك احتمال بأنها كانت فعلاً منتبهة للدرس. وعندما سألت عما إذا كان هناك أثرٌ إيجابي من تقليل استخدام الجوال، أجاب ١٥% بلا، و ٦٥% - أي الثلثين - بنعم، و ١٩% بأنهم يعتقدون ذلك. وذكر ٥٠ % - أي النصف - أن من الإيجابيات زيادة التواصل المباشر والفعال. وكتب أحد الطلاب: "لقد لاحظت كيف كان الهاتف مسيطراً على حياتي".
وكتب آخر": أقدّر حقاً الوقت الذي أقضيه في الاستحمام لأنه الوقت الوحيد الذي يجبرني على الاستغناء عن هاتفي، واستغلاله في التفكير بدلاً من التصفح بلا فائدة". كان هدفي من هذه التجربة حثّ الطلاب على التفكير في عاداتهم بدلاً من فرض التغيير عليهم. ولذلك يجب أن يعتاد الطلاب على توجيه الأسئلة للمسؤولين، بما فيهم أنا. وهذا أمر سهل بالنسبة إليّ، فقد طلبت من الجيل القديم أن يبحثوا عن أدلة تؤكد أن الحياة قبل الأجهزة الذكية أفضل منها الآن. واعترف طلابي بأنهم لا يعرفون كيفية قراءة الخرائط وأنهم يعدّون الكتابة على الورق وقراءته عادة عفى عليها الزمن. كما أنهم لا يستطيعون حفظ المعلومات المتاحة لهم في محرك البحث، وهذه حقائق وليست اعترافات، فهناك بعض التغييرات البسيطة التي لا تحتاج إلى تقييم. ولكن يتفق معظم الطلاب بأن استخدام الجوال غير ملائم في القاعات الدراسية. ويرى ١١% منهم فقط بأنه لا داع لوضع سياسة تحِد من استخدامه.
لماذا نستخدم الجوالات في القاعات الدراسية؟
يقول ٤٨% من الطلاب – في بداية الفصل الدراسي - أنه كلما كانت البيئة الدراسية خالية من المشتتات، ساعد هذا في خلق بيئة ملائمة للتعلم. ونظراً لذلك فإنني أتساءل: لماذا ما نزال نحاصر أنفسنا بالجوالات في القاعات الدراسية؟ استخدم ٢٠% - أي خُمس الطلاب - عبارة الإدمان، وهي العبارة التي يحاولون دائماً تجنبها. وذكر العديد منهم الملل كدافع. وتعُد الأعراف المجتمعية – لسوء الحظ - استخدام الجوال أمراً مقبولا عند الشعور بالملل. وقد ذهب الفيلسوفان (سورين كيركغور) و(بيرتراند راسل) إلى أن الملل يعد شيئاً أساسياً، فهو يشعل الخيال والطموح. ولا يترتب عليه ضرر يدعو إلى إنقاذ الطلاب منه. وأعرب أحد الطلاب عن رأي اختزالي، حيث قال: "نحن حمقى، ولا نستطيع السيطرة على أنفسنا". أنا أقدّر هذه الملاحظة البليغة، ولكن يقلقني الإصرار الذي يبدو فيها. فإذا كنا نطلق على أنفسنا لفظ "حمقى"، فما الهدف من إزعاج أنفسنا بمحاولة البحث عن عيوبنا ومحاولة إصلاح ذواتنا إذا كنا لا نستطيع السيطرة على حياتنا؟ أضحت التقنية جزءًا من حياة البشرية. وهي لا تعد جيدة أو سيئة بحد ذاتها، ولكن هذا عائد إلى استخدامنا لها. بينما يقول ٣٩% من الطلاب بأن أفكارهم وسلوكياتهم لم تتغير بعد معرفتهم بآثار استخدام الجوالات، وحاول ٢٨.٥% التقليل من استخدامه، وأصبح ٢١.٥% أكثر وعياً إزاء كيفية استخدام الجوال، والوقت الذي يقضيه بصحبته. أما نصف الطلاب فأصبحت لديهم نظرة نقدية حيال دور الهاتف في حياتهم، وهذه هي الخطوة الأولى في توجيه علاقتنا مع التقنية، بدلاً من جعل التقنية تسيطر علينا. ومع ذلك أرغب بتكوين تصور لما سيؤول إليه جيل طلابي. ولذلك وجّهت إليهم سؤالاً عما إذا اتيحت لهم فرصة زرع جوال في أجسادهم – كما توقع قادة الصناعة في منتدى (دافوس) الاقتصادي العالمي عام ٢٠١٦م –
وهنا إجاباتهم: ٧% نعم، فكلما كنت أقرب إلى جوالي، كان ذلك أفضل. ٧% نعم، فهذا أمر لا مفر منه. ٧% يعتمد على التكلفة. ١١% يعتمد على عدد من يقوم بذلك. ٣٦% يعتمد على المخاطر الجسدية. ٣٢% مستحيل. يفكر ثُلثا الطلاب بجعل هواتفهم جزءًا من أجسادهم. والذي يعني تقبّلهم لكافة العواقب المترتبة على ذلك، ولتحقيق الإشباع الفوري، والتبعية في المعلومات. ومع كل هذه الأسئلة الافتراضية ربما يستطيع البعض وضع هواتفهم جانباً عندما تتاح لهم الفرصة، ويتذكرون هذه الأيام بشيءٍ من الحنين لطريقة حياتهم في الطفولة. ذكر (دانيال كوين) في روايته "إسماعيل" عام ١٩٩٢ على لسان القرد إسماعيل: "إن الإنسان اعتاد على الأسر" ، قال التلميذ: "أشعر بأني أسير، وأجهل السبب". فأجابه إسماعيل: "لأنك لم تستطع أن تجد قضبانًا هذا السجن". عندما أفكر بتجربة (يندر) لا أنفك عن التفكير بفكرة إسماعيل؛ فقد تحدّث عن مشتتات البيئة، ولكن رؤيته تنطبق أيضاً على استخدام الإنسان للتقنية، فيجب أن تكون داعماً للتقنية، خصوصاً الأجهزة الذكية منها، حتى تكون متحضراً. فعن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات ندفع الفواتير، ونتواصل مع العائلة والأصدقاء، ونعرف الأخبار، ونقدّم طلباً على الوظائف والجامعات، ونحصل على الرعاية الصحية؛ فيجب أن نتكيّف مع هذا، فالطرق القديمة لم تعد تجدِ نفعاً. ولكن تعود إلينا طريقة التكيّف. فهل نقف في طابور لنحصل على الأيفون الجديد بمبلغ ٩٩٩ دولارا؟ أو نراسل شخصًا موجودًا معنا في نفس الغرفة؟ أو نضع الهاتف على الطاولة وقت العشاء؟ وهل نختار الاعتماد على التقنية كحلقة وصل مع الأشخاص والتقليل من مقابلتهم وجهاً لوجه؟ أخيراً، إن حرية الاختيار هي ما ترمز إليه حقائب (يندر). ربما لم تسلك الشركة طريقة مختلفة، ولكنه كان حلاً مؤقتاً لطلابي. وآمل أن يصدر القرار عن تفكير ورغبة حقيقيتين إذا ما أراد أحدهم زرع أجهزة ذكية في جسده وليس مجرد اتّباع أعمى. وألا يكون إغلاق هواتفهم دائما نتيجة لأمر من أستاذ جامعي.
تابع قراءة عشرات المقالات الملهمة على زد

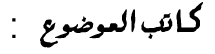 youssef
youssef
